هل كل ثقافة تستحق الحماية؟ في نقد فكرة "الهوية كقيمة مطلقة"
مقال فلسفي يستكشف حدود فكرة الهوية كقيمة مطلقة، ويفكك وهم الأصالة حين تُستخدم لتبرير الجمود الثقافي. هل كل ما نعتز به يستحق الحماية؟ وهل الهوية تُبنى على ما يُكرم الإنسان أم ما يُقيده؟ قراءة تأملية في معنى التطور الثقافي ونضج المجتمعات.
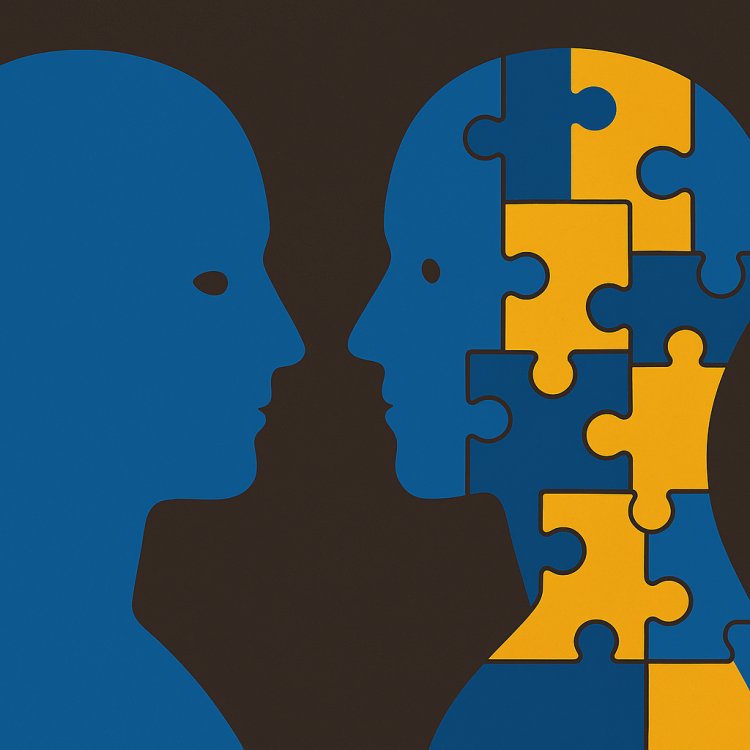
الهوية: حين تصبح مقدسة
تواجهنا المجتمعات الحديثة، ومعها مساحات شاسعة من الوعي الإنساني المعاصر، بإشكالية متصاعدة حول مفهوم "الهوية" وحدودها. ولئن كانت الهوية – من حيث الأصل – وسيلة لتعريف الذات وتثبيت أركان الانتماء في عالم متغير، فإن ما آل إليه فهمنا لها، وتحويلها إلى قيمة مطلقة لا تُناقش، قد حوّلها في أحيان كثيرة إلى أداة قمع لا تختلف كثيرًا عن أشدّ الأيديولوجيات صلابةً. فهل كل ما نُسميه "هوية ثقافية" يستحق الحماية؟ وهل الأصالة في ذاتها فضيلة، أم أنها، في بعض تجلياتها، مجرد حجة أنيقة لاستدامة ما هو دوني أو قمعي؟
ليست كل هوية جديرة بالصون. هذه هي الجملة التي يجب أن نتشجع لننطق بها، ولو خالفت الأعراف الشائعة. لأن الحماية الأخلاقية لأي منظومة – بما في ذلك الثقافات والهويات – يجب أن تُمنح وفقًا لمقدار ما تُضيفه من كرامة ووعي وعدالة، لا لمجرد قِدمها أو ارتباطها العاطفي بالمجتمع.
من يراقب التحولات الاجتماعية في السياقات العربية يدرك أننا نعيش زمنًا اختلطت فيه الأصالة بالتكلس، والوفاء بالجمود، والهوية بالفخ السردي الذي يحول دون التقدّم. ليست المشكلة في الاعتزاز بالهوية، وإنما في ربط كل نقد لها بالخيانة والانسلاب. فبعض ما نُقدّسه تحت لافتة "الهوية" لا يعدو كونه تكرارًا لعنفٍ غير معلن – عنف يتموضع في الأعراف، ويتسرّب في التربية، ويتغلغل في الخطاب، حتى يغدو سمة للفضيلة بدلاً من أن يكون نقيضًا لها.
فكيف تحولت الهوية من إطار حيوي للتميّز إلى سجن مفاهيمي؟ وما الذي يجعلنا نُقدّس عناصر ثقافية لمجرد أنها "موروثة" دون أن نسأل عن آثارها الحقيقية على الإنسان ووعيه وكرامته؟ إن الخطورة لا تكمن في الفخر بالانتماء، بل في تجميد الوعي عنده، ومن ثمّ استبعاده كمساحة للنقد والمساءلة.
الهوية ليست عِرقًا بيولوجيًا، وليست لباسًا خارجيًا، ولا تقليدًا اجتماعيًا متوارثًا فقط، بل هي منظومة سردية تحمل ما نرغب في الحفاظ عليه من الماضي وما نختاره ليكون وجه المستقبل. إنها خيار واعٍ أكثر من كونها قدَرًا موروثًا. وبالتالي، فإن الدفاع عن الهوية يجب أن لا يكون دفاعًا أعمى عن كل مكوّناتها، بل تمرينًا مستمرًا على التمحيص والنقد والغربلة.
الهوية كآلية دفاع نفسي — حين يتحدث "الهوى" باسم "الهوية"
ما نُسميه في كثير من الأحيان "تشبثًا بالهوية" لا يكون، في حقيقته النفسية، إلا صدى لخوفٍ عميق من الذوبان، ومن فقدان الذات في محيطٍ يُعيد تشكيل الأفراد وفق مقاييس جديدة قد تبدو – لأول وهلة – غريبة أو مهدِّدة. فالدفاع المستميت عن الهوية ليس دومًا تعبيرًا عن اعتزاز واعٍ بها، بل كثيرًا ما يكون انعكاسًا لهشاشة داخلية لم تجد سندًا غير التمترس خلف الجدران النفسية للثقافة والانتماء.
تدلنا تجارب علم النفس الثقافي والتحليل الاجتماعي على أن الإنسان حين يفقد شعوره بالقيمة الذاتية أو تتعرض هويته الشخصية للاهتزاز، يلجأ تلقائيًا إلى الانخراط في جماعة أو هوية جمعية تمنحه شعورًا بالتماسك والشرعية. بهذا المعنى، تصبح "الهوية" في بعض الأوقات تعويضًا لا عن وضوح الذات، بل عن غموضها؛ لا عن استقرارها، بل عن قلقها. ويبدأ الهوى في التحدث باسم الهوية، وتتحول مقولات مثل "هكذا نحن"، "هذه عاداتنا"، أو "هويتنا لا تُمسّ" إلى دروع سيكولوجية تُستخدم ليس للدفاع عن المعنى، بل للهروب من مواجهة الذات وتحولاتها.
نلحظ في هذا السياق نمطًا متكررًا في المجتمعات ذات التاريخ الاستعماري أو تلك التي تعرضت لصدمات ثقافية كبرى، حيث تتضخم "الهوية" كموضوع مقدس بالتزامن مع شعور جمعي بالإذلال أو فقدان الاعتبار. ومن ثم، فإن الهوية لا تُمارس حينها كخيار واثق، بل كتعويض غريزي. يتحول الناس إلى حراس للرموز، لا لأنها بالضرورة تستحق الحراسة، بل لأنها باتت كل ما تبقى لهم من صورة الذات في مواجهة عالم يراهم دومًا أقل.
هذه الديناميكية النفسية تفسّر لماذا يصبح بعض الأفراد أكثر حساسية تجاه النقد الثقافي، ولماذا يتضخم ردّ الفعل ضد أي محاولة لمراجعة العادات أو إعادة قراءة الموروث. لأن النقد هنا يُفسر تهديدًا لهوية الجماعة، أي لآخر حصن من الشعور بالمعنى والكرامة. وكأننا نقول ضمنيًا: "دعوا لنا ما تبقى من وهم العظمة، حتى لو كان جاثمًا على صدر الحقيقة".
ولكن ما لا يُقال هو أن التقديس المرضي للهوية لا يُنتج إلا مزيدًا من الجمود، والخوف، والتكرار. فلا نعود قادرين على التغيير، لأن أي تغيير يُفهم خيانة، ولا نعود قادرين على الاعتذار عن الخطأ، لأن الاعتذار يُفسَّر ضعفًا أو خضوعًا. فنحاصر أنفسنا، دون وعي، في دائرة مغلقة: نريد الاحترام من العالم، ونرفض أن نراجع أنفسنا أمامه.
إعادة وزن الأصالة — من قداسة الجمود إلى نضج الهوية
ثمة مفارقة تستحق التأمل بعمق: كيف يمكن لمجتمعٍ أن يرفع شعار الأصالة، ويجعل منها مبررًا لتكرار ما لا يتوافق مع شروط الارتقاء؟ وكيف يُعقل أن تصبح "الهوية" مشروعًا جامدًا، في حين أن كل ما في الحياة يشير إلى أن البقاء ذاته مشروط بالتحول؟
الطبيعة — أعظم المُعلمين — لا تحفظ إلا ما يصلح للحياة. قوانين التطور في الكائنات، في البيئات، في النظم المعقدة، كلها تقول بلغة صامتة: ما لا ينمو يذبل، وما لا يتغير يندثر. فلماذا نستثني الثقافة من هذا القانون؟ ولماذا نُعامل الهوية كما لو كانت "أيقونة" محفوظة في متحف التاريخ، وليست نسيجًا حيًا يحتاج إلى تنقية وتنمية؟
إن القيمة الحقيقية لأي "أصالة" لا تكمن في قِدمها، بل في صلاحيتها للاستمرار. فبعض ما نعتبره أصيلاً، لا يعدو أن يكون بقايا أنظمة نفسية بدائية — ذكورية مفرطة، أو قبلية ضيقة، أو تراتبية مريضة — نرثها دون مساءلة، ثم نتغنى بها على أنها جزء من هويتنا، في حين أن الطبيعة لو خيرت، لنبذتها كما نبذت أنواعًا كثيرة لم تعد تواكب الحياة.
الهوية الناضجة ليست تلك التي تُحصّن نفسها من النقد، بل التي تحتفظ بما هو سامٍ وتنقي ما هو سامّ. هي هوية تراجع مكوناتها، كما يفعل العاقل حين ينظف بيته: يُبقي ما يمنح الدفء، ويتخلص مما تراكم من غبار. إنها عملية مستمرة من التطوير الواعي، تضع "الكرامة الإنسانية" و"الفعالية المستقبلية" كمعيارين مركزيين لصلاحية أي عنصر من عناصر الثقافة.
فما يُكرم الإنسان، ويُطلق قدراته، ويزيد من حضوره في العالم، يُعتبر جزءًا من الهوية النبيلة. وما يُحقره، ويكبت نموّه، ويُغرقه في لاجدوى السرديات القديمة، فمكانه لا ينبغي أن يكون موضع تبجيل.
إن بناء هوية أفضل لا يعني خيانة الماضي، بل وفاء أعمق له عبر تطويره. فالأب الحكيم لا يورث أبناءه طعام الأمس، بل يغرس فيهم القدرة على زراعة طعام الغد. وكذلك المجتمعات الراقية، لا تُسلّم الأجيال القادمة مفاتيح سجن باسم الهوية، بل تضع بين أيديهم أدوات التفكيك والبناء، ليصنعوا ذاتهم من جديد، ويتركوا بصمتهم كما فعل من قبلهم.
في النهاية، لن تُقاس الهويات بمدى تشبثها بما كان، بل بمدى قدرتها على توليد ما يجب أن يكون. وبهذا فقط تتحول الهوية من درع دفاعي إلى بوصلة نهضوية، من حائط يُغلق الأفق إلى نافذة تفتحه.




















